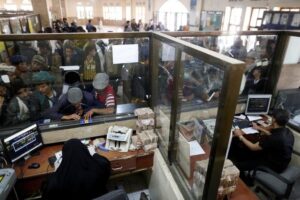مع تصاعد الحرب في غزة خلال العامين الماضيين، شهدت الضفة الغربية موجة متصاعدة من هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وصلت إلى مستويات عنف يومي لم تشهدها المنطقة من قبل.
اعتداءات منظمة، مكررة ومسلحة، تستهدف المزارعين والرعاة والقرى الصغيرة، وتأتي وسط شعور متزايد لدى الفلسطينيين بأن قوات الأمن الإسرائيلية تتسامح مع هذه الميليشيات أو تتواطأ معها عملاً أو تقاعسًا.
وأصبحت قرية الطيبة المسيحية، الواقعة شمال الضفة، نموذجًا صارخًا لهذا النمط من العنف. سكانها يتعرّضون لهجمات متكررة خلال موسم قطف الزيتون؛ مستوطنون ملثمون يهاجمون الحقول، يحرقون المركبات، يسرقون المحصول، ويهاجمون المنازل.
وتوضح شهادات سكان مثل يوسف موسى، البالغ من العمر 64 عاماً، حجم الانتهاكات: اقتحام للخيمة العائلية، ضرب حتى الإغماء، سرقة أموال ومواشي وممتلكات شخصية، واحتجاز لكرامة عائلات كاملة. عندما طلبت الإسعاف، يقول سكان الطيبة إن الجيش أحيانًا رفض فتح البوابات للوصول إلى القرية، أو تأخر في الاستجابة إلى أن مغادرة الجناة تكفلت بحماية نفسها.
ولا تقتصر الاعتداءات على الطيبة. تقارير متكررة أفادت عن هجمات في محيط نابلس ورام الله وبيت لحم وترمسعيا، حيث تعرض مزارعون ومتطوعون أجانب للضرب والإهانات وإشعال النيران في الآليات.
ووصف ناشطون محليون هذه المجموعات بـ«الميليشيات الفاشية» لأن عنفها يجري وفق أيديولوجيا عنصرية تبرّر إقصاء الفلسطينيين وتجريدهم من سبل معيشتهم.
ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن ما يحدث ليس ظاهرة عشوائية بل سياسة فعلية تكاد تكون مدعومة من جهات رسمية.
الوزير بيتسلئيل سموتريتش، صاحب رؤية واضحة لتوسيع الاستيطان وضم مساحات واسعة من الضفة، يعتبره كثيرون محفزًا سياسياً لهذه الحملة.
ومؤخراً أعلن سموتريتش خطة طموحة لضم نحو 82% مما يسميه يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفي أغسطس/آب صادق على مشروع E1 الذي يبني آلاف الوحدات السكنية ويقفل الطريق بين القدس والضفة، ما يعني عملياً تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفرض واقع جديد يصعب عكسه سياسياً.
ووثقت المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والدولية نمطاً من الإفلات من العقاب: شكاوى الفلسطينيين إلى الشرطة والسلطات غالباً ما تبوء بالفشل، والتحقيقات إما تتأخر أو لا تُفضي إلى محاسبة فعالة، وفي المقابل يتم تشجيع أو دعم المستوطنين سياسياً من قبل مسؤولين بارزين.
وأدى هذا الفعل المزدوج — العنف في الميدان مع تغاضي رسمي —إلى شعور فلسطيني بأن هناك “عملية تطهير ديموغرافي” تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من أراضيهم.
والعنف يأخذ أيضاً طابعاً ثقافياً ودينيّاً؛ استهداف كنائس ومواقع تراثية في قرى مثل الطيبة يمثل محاولة لتقويض النسيج الاجتماعي والتاريخي لتلك المجتمعات.
وسلطت زيارة دبلوماسيين غربيين، بينهم السفير الأمريكي آنذاك مايك هاكابي وأعضاء مجلس شيوخ، ضوءاً مؤقتاً على الأزمة لكنها لم توقف التدهور.
النتيجة المباشرة هي فقدان سبل العيش وارتفاع معدلات الخوف والترهيب، وهروب رعاة ومزارعين من الأرض. وعلى المستويين السياسي والإنساني، يجعل هذا الواقع حلّ الدولتين أو أي تسوية عادلة أمراً أكثر تعقيداً، إذ تصبح الأرض المعيشة للفلسطينيين مجزأة إلى جزر معزولة محاطة بمستوطنات متصاعدة بنفوذها وسلاحها.
وبالمجمل فإن الحرب في غزة لم تكن العامل الوحيد لكنّها كانت الشرارة التي سمحت لمجموعات مسلحة يمينية ومؤثرة سياسياً بأن تتصاعد وتتحول إلى تهديد يومي للمدنيين الفلسطينيين في الضفة.
ومع استمرار هذا المزيج من العنف السياسي، والتواطؤ الأمني، وتوسع الاستيطان، تبدو الضفة على شفا تحول ديموغرافي وجغرافي قد يغيّر ملامح المنطقة نهائياً ما لم يُتخذ تحرك دولي وداخلي جاد لوقف دائرة العنف وحماية المدنيين.