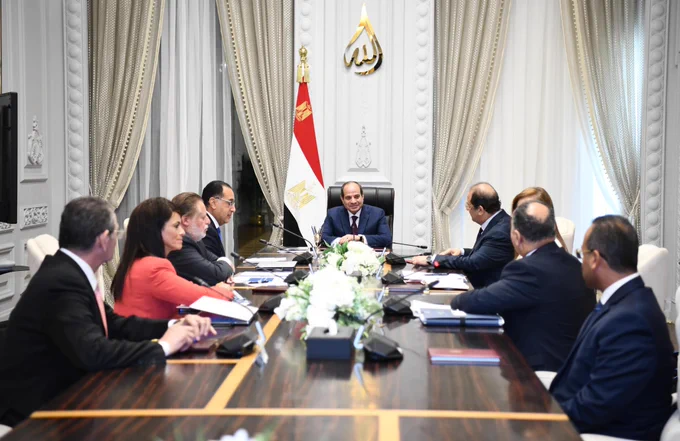قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان من المفترض أن ينقذ مصر يشرف الآن على خرابها.
وذكرت المجلة أن معدل التضخم بلغ في مصر 37٪ تقريبا، وبلغ سعر الدولار الواحد 30 جنيها مصريا بعد أن كان حوالي 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي السلطة.
ولفتت إلى أن الدين الدولي لمصر وصل ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ديونها إلى نحو 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023.
وأبرزت المجلة أنه طوال معظم صيف 2013، كانت مصر في قبضة ما يمكن وصفه بـ “هوس السيسي“..
فقد أشادت الأغاني والشطائر ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى ملابس النوم بعبد الفتاح السيسي، الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.
حين النظر إلى ذلك من الخارج، كان مشهدًا غريبًا.. ملايين المصريين مبتهجون بالتدخل العسكري القاسي والوحشي ضد جماعة الإخوان المسلمين الذين وصلوا الرئاسة قبل عام واحد فقط .. في يونيو 2012.
لقد بدا ان من يسمى بالثوار ومنتقدي النظام السياسي الاستبدادي ايضًا كانوا يعشقون بصدق القائد العسكري ذا الحجم الضئيل الذي وعدهم ببداية جديدة بعد ثمانية عشر شهرًا صاخبة بدأت بالانتفاضة ضد الزعيم القديم حسني مبارك في أواخر يناير 2011.
مع سجن مرسي ومقتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو اعتقالهم أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل، رغم أنه حذر مواطنيه من التحلي بالصبر، وكانت تلك خطوة حكيمة منه، فقد تفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة في مصر مع انتقال مصر من أزمة إلى أخرى خلال فترة الانتقال الديمقراطي المشحونة والقصيرة الأمد.
بعد مرور عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم، بل على العكس تمامًا، فالرجل الذي كان من المفترض أن ينقذ مصر يشرف الآن على خرابها!
لقد وعد السيسي المصريين بالازدهار، لكن مصر مفلسة تمامًا والاحصائيات مذهلة بهذا الصدد..
والأمور المالية في مصر تبدو مثل لعبة خادعة، وتقوم على تحريك الأموال بصورة مستمرة في محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية غير المستقرة في البلاد.
أكد السيسي مرارا أن المحن الاقتصادية في البلاد هي نتيجة قضايا خارجة عن إرادته، لا سيما جائحة كوفيد 19 وغزو روسيا لأوكرانيا، ولا شك في أن هذه الأزمات خلقت تحديات اقتصادية كبيرة واجهت البلدان كافة صعوبة في ادارتها بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فمن الواضح أن حجج السيسي هي استراتيجية استطرادية للتقليل من مسؤوليته في المزيد من الفقر المدقع في مصر.
لقد انخرط الرئيس في فورة إنفاق تغذيها الديون على مشاريع عملاقة ليس لها سوى القليل من المبررات الاقتصادية، اقواها وأكثرها فحشًا هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي هي في مرحلتها الأولى فقط وقد بلغت تكلفتها حتى الآن أكثر من خمسة واربعين مليار دولار.
عندما انسحبت الإمارات والصين من المشروع، اضطر المصريون لدفع كل الفاتورة عن طريق إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى الميزانية العمومية للبلاد.
بالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة في وسط الصحراء، يشرف السيسي على مجموعة من المشاريع الكبيرة الأخرى ومن أبرزها “العاصمة الصيفية” الجديدة على الساحل الشمالي، ومحطة الطاقة النووية (في بلد به فائض من الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل.
وإحياء مشروع ضخم فاشل في عهد مبارك في المنطقة العليا سمي مصر توشكى، ويأتي ذلك كله بعد افتتاح الطريق الالتفافي لقناة السويس – الذي أطلق عليه اسم “قناة السويس الجديدة” – عام 2015.
معظم هذه المشاريع ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها لكنها مهمة من الناحية السياسية أو ربما كانت.
كان من المفترض أن تكون علامات ملموسة لولادة مصر من جديد تحت اليد الثابتة للضابط العسكري الجديد الذي تحول إلى رئيس وزملائه في وزارة الدفاع المصرية.
ربما كانت الرسالة أن مصر لا يزال بإمكانها القيام بأشياء عظيمة، لكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية لا يمكن تحملها على البلاد وأشار مسؤولون إلى أن الكثير من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع.. طيب انه امر مبرر ولكن بأي ثمن؟
تتحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، ولكن الفوائد طويلة الأجل يجب أن تفوق التكاليف قصيرة الأجل.
الجسور الجديدة والطرق والتقاطعات وتحديثات المطارات ومترو الأنفاق تستحق العناء – وقد فعلت مصر بعضاً من ذلك – بسبب العائد على هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر كفاءة.
قد يتناسب طريق قناة السويس الالتفافي مع هذه الفئة، لكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن حُفر هائلة التي تأكل الاموال والتي لا تملكها مصر في الاساس.
من الصعب أن نفهم أنه في غضون عقد من الزمن، استولى السيسي على دولة فقيرة وجعلها أكثر فقرًا بالرغم مما قام به رعاته في السعودية والإمارات من اعادة تعويم للاقتصاد المصري عبر تحويلات نقدية مباشرة، وحصوله على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة، وتمتعه بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية.
في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش، ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من المشترين.
ذلك لأن هذه الأصول إما لا تساوي شيئًا ولا أحد يعرف كيف يحدد لها قيمة، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري (والذي سيكون الرابع منذ مارس 2022) حتى يتمكنوا من الحصول على شركات عالية الجودة بأسعار أرخص.
في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية الواسعة الانتشار.
لقد انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة، وبيع الاصول المملوكة للدولة بطريقة بيع البضائع بعد ان تكون مخازنها قد اكلتها النيران بالكاد تعتبر خطوة تعبر عن الاحترام.
بدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم، يغادر المصريون بلادهم بأعداد متزايدة، فقد فات في كثير من التقارير التي تحدثت عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في يونيو، حقيقة أنه ربما كان هناك 300 إلى 350 مصريًا على متنه، وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011 ، فقد ارتفع أكثر في السنوات الأخيرة.
خلال شهر يونيو، حاول أكثر من ستة الاف مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023، وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.
في عام 2022، سعى حوالي 22000 مصري إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط، ويبدو ان من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
المتاعب الاقتصادية الحالية في مصر تعزز فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة.
في سبعينيات القرن الماضي، باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قصة عن كيف كانت مصر لاعباً مؤثراً يمكن أن يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت.
السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) كان يبالغ، فمصر شريك مهم للولايات المتحدة، ومع ذلك ومع استثناءات قليلة – مثل عملية درع الصحراء/عاصفة الصحراء – لم يكن لديها أبدًا الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو السياسة الأمريكيون يأملون فيه عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية نحو الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت مؤخرًا في سانت بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي + 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي.
يمنح التواجد في الغرفة قدرًا معينًا من التأثير، لكن مصر هي مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعبًا.
المثال الأكثر وضوحا على نزول مصر وما صاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد.
في المرحلة الأولى من الصراع، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – كرهائن وتم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين.
بعد تلك الحلقة المهينة، وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورًا مهمًا في إجلاء رعايا الدول الثالثة من السودان، ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين).
يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالخجل من أن السعودية قد انتهى بها الأمر إلى لعب الدور الحاسم في صراع حيث يجب أن تتولى مصر – وفقًا لأساطيرها – زمام القيادة.
في الواقع، عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة من جيران للسودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار، حتى ذلك لم يسر على ما يرام، لقد كان أكثر بقليل من مؤتمر لتبادل الاحاديث والصور الفوتوغرافية، وخلال تصريحاته في الاجتماع السري، شكر الزعيم الإثيوبي أبي أحمد السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.
في الآونة الأخيرة، غرد محلل مصري ماهر قائلًا “يمكنني القول بصراحة أنني لم أعد أرى مخرجًا من هذا“، وأظن أنه قصد بكلمة “هذا” الدمار الذي أحدثه السيسي لمصر.
بعد عقد أو نحو ذلك من انتفاض المصريين للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، لم يكن لديهم أي من هذه الأشياء.